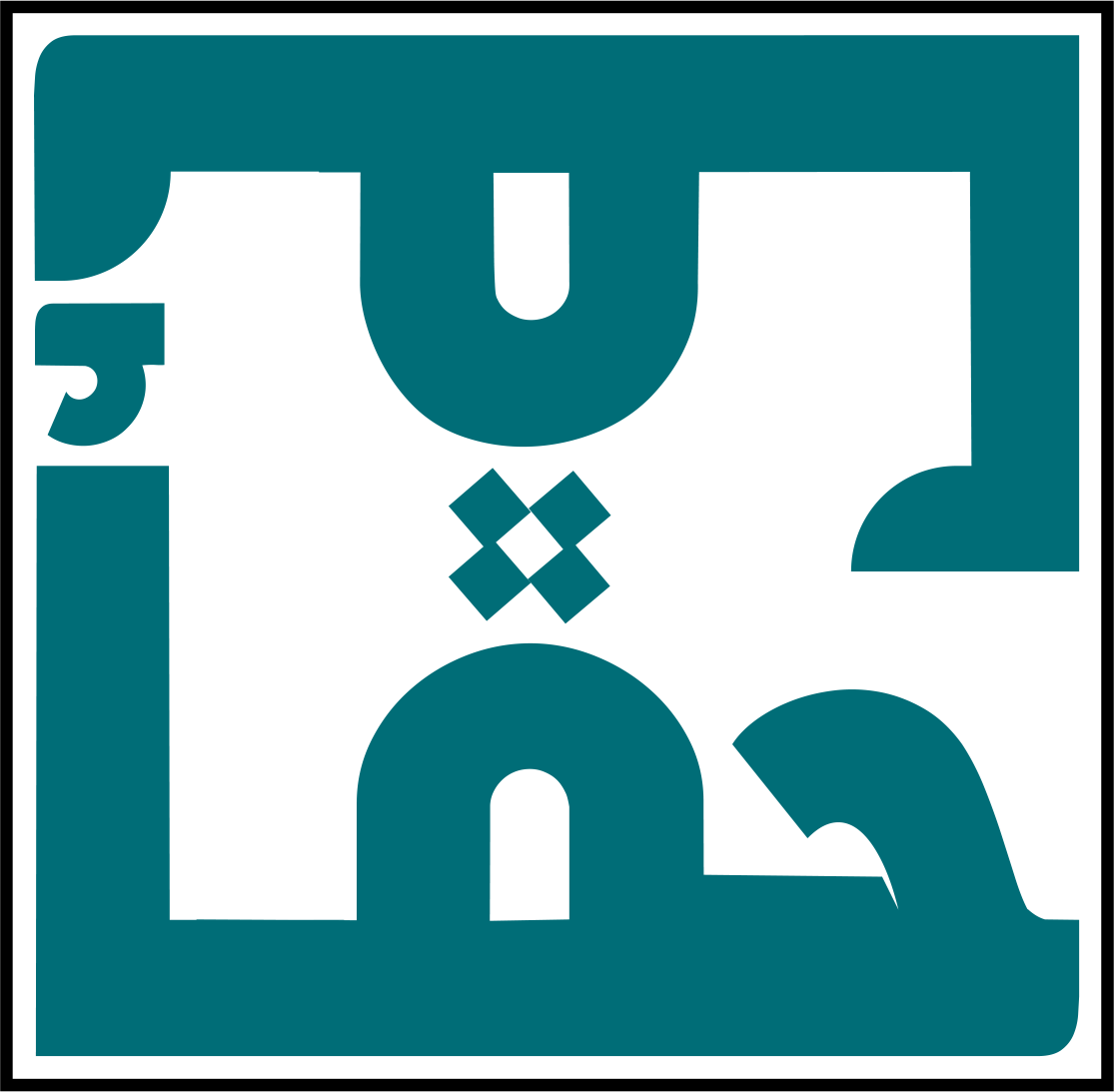عندما دعمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية انقلاب الجيش الذي دمّر الديمقراطية البرلمانية في سورية في عام 1949، كان المجال مفتوحاً أمام الضباط العلويين كي يسيطروا على الوضع في عام 1966 (تطلب صمودهم على مر قرون من التعصب الديني أن يصبحوا أسياداً في التآمر).
منذ 25 عاماً، سافرتُ براً عبر المنطقة التي كان يسميها علماء الجغرافيا “سورية الكبرى” لتأليف كتاب. بدأتُ بمنطقة الإسكندرونة، تلك المحافظة الشمالية البحرية التي تنازلت عنها فرنسا لتركيا في عام 1939، ثم توجهتُ جنوباً عبر سورية المعاصرة باتجاه لبنان. انطلاقاً من هناك، كنت أنوي المرور بإسرائيل والأردن. كنت سأتوجه نحو العقبة، أول معقل تركي في سورية الكبرى يستسلم للثورة العربية و”لورنس العرب” في عام 1917. لكن لأسباب متنوعة، اختصرتُ رحلتي وتوقفت في بيروت في يونيو 1987. (عدتُ لإتمام الرحلة وتأليف كتاب ثان في عام 2002).
كانت الجولة التي قمتُ بها سيراً على الأقدام أو بالحافلة أو في سيارة الأجرة كافية بالنسبة إلي كي أفهم طبيعة سورية بطريقة لم أكن أفعلها حين كنتُ صحافياً ملتزماً بمهل زمنية يومية محددة. كان الناس يحبون تجاذب الأحاديث، وتناول القهوة والشاي، ولعب الورق، والتذمر من الوضع. كان حافظ الجمالي واحداً من أبرز منتقدي نظام البعث القائم منذ 17 عاماً بقيادة الرئيس حافظ الأسد. كان الجمالي رجل دولة ودبلوماسياً مميزاً في الثمانينيات من عمره، وكان أحد مؤسسي حزب البعث. لكن بحلول عام 1987، كان ينتمي إلى المعارضة السورية الصامتة.
أخبرني الجمالي حينئذ: “كان الجميع خائفين. أنا قبلتُ أن أكون وزيراً. لماذا؟ لأنني لو لم أوافق، كنت سأدخل السجن. لا أحد يتمتع بالشجاعة لإخبار رئيسنا بوجود خطب ما. يظن رئيسنا أنه شخص ملهم وتربطه علاقات مميزة مع الله. لو كان ملهماً فعلاً، فلا بأس بذلك. حين تقع أي أزمة، كان يشير إلى وجود مؤامرة إسرائيلية أو أميركية. أما هو، فلا علاقة له بالمشكلة لأنه شخص ملهم”.
عمد بعض الأعضاء المدنيين في حزب البعث إلى ترك صفوفه عندما وصل الحزب إلى السلطة في عام 1963، علماً أن مؤسسي الحزب ادعوا أنهم يؤمنون بالعلمانية والديمقراطية، فرفضوا أن يتخذ الحزب طابعاً عسكرياً. بقي الحزب في السلطة، لا عن طريق الانتخابات، بل بقوة سواعد أعضائه داخل الجيش. كان والد رولا ركبي، التي قابلتُها منذ بضعة أسابيع في الفندق الذي تديره في دمشق، واحداً منهم. توفي فيصل ركبي منذ شهر، ما يفسر ارتداء ابنته ملابس سوداء. تدعم ركبي الثورة التي بدأت في سورية خلال السنة الماضية، وهي تظن أن نضالها يشبه نضال والدها ضد الحكم العسكري الذي يقوده حزب واحد.
في المقهى التابع للفندق الذي يطل على شارع مكتظ في وسط المدينة، أخبرتني ركبي: “تعرضتُ للاستجواب مرتين من قوى الأمن. لقد قامت تلك القوى باستجوابي كي تثبت لي أنها تعلم بما أقوم به وأنها تراقب كل ما يحصل”. لقد قالت ذلك لأن المعارضين الشباب اجتمعوا في ذلك المقهى مع حواسيبهم بعد أن قطعت الشرطة خدمة الاتصال اللاسلكي عن الفندق. لكن عمد بعض الشبان هناك إلى مناقشة مسار الثورة (تماماً كما فعل أجدادهم في مقاهي الأسواق القديمة التي دمّرها الفرنسيون بهدف إخماد ثورتهم) وكانوا يتناولون هذه المرة القهوة التركية الحادة أو قهوة الإسبريسو الرائجة راهناً.
رصدت ركبي وجود شرخ بين الأجيال في هذا الصراع: “يعبّر أشخاص كثيرون هنا من القوميين المنتمين إلى الجيل القديم عن ولائهم للنظام لأنهم يظنون أنه يعادي الإمبريالية والمشروع الصهيوني”. برز انقسام اقتصادي أيضاً في هذا المجال: “في دمشق، وحدها طبقة الفقراء تشارك في الثورة. في حمص، تشارك جميع الطبقات وجميع الطوائف. إنها ثورة بمعنى الكلمة”.
يؤوي فندقها 30 عائلة هربت من المعركة في مدينة حمص التي تحولت إلى مركز للثورة وحملة القمع. استناداً إلى الأحاديث مع اللاجئين من حمص، اتضح وجود مصدر انقسام طائفي آخر. كان السُّنة من حمص يميلون إلى الهروب خوفاً من مدفعيات الجيش وحملات الاعتقال، بينما سعى المسيحيون والعلويون إلى الاختباء من الأصوليين السُّنة الذين يعاملونهم كأعداء لهم أو كأشخاص أدنى مستوى منهم.
بالعودة إلى عام 1987، أخبرني الجمالي: “حين قاومنا الفرنسيين، اضطررنا إلى التحرك كشعب موحّد. أما الآن، فنحن منقسمون. نحن مسلمون. نحن علويون. نحن دروز. نحن مسيحيون. كيف حصل ذلك؟ تحررت سورية خلال الأربعينيات من الصراع الطائفي، ولكنها عادت لتنقسم الآن إلى طوائف عدة. يتألف الجيش اليوم من ضباط علويين. لكن من المعروف أن غالبية الجيش تمثل أقلية شعبية. هل الأمر مصادفة؟”.
عندما احتلت فرنسا سورية في عام 1920 وقسّمتها إلى أربع دويلات صغرى، كان معظم السُّنة والمسيحيين هم من القوميين العرب الذين يعارضون الحكم الفرنسي. فرفضوا خدمة قوات المشرق الخاصة التي تحولت لاحقاً إلى الجيش السوري. لذا جنّد الفرنسيون الفلاحين العلويين الفقراء. كانت مكانة العلويين في القوات المسلحة إرثاً للحكم الاستعماري الوحشي الذي دام 25 عاماً. ساعد العلويون الفرنسيين على قمع الثوار القوميين خلال العشرينيات (علماً أن بناتهم تعرّضن لسوء المعاملة وعملْنَ كخادمات في دمشق حتى الفترة الأخيرة).
عندما دعمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية انقلاب الجيش الذي دمّر الديمقراطية البرلمانية في سورية في عام 1949، كان المجال مفتوحاً أمام الضباط العلويين كي يسيطروا على الوضع في عام 1966 (تطلب صمودهم على مر قرون من التعصب الديني أن يصبحوا أسياداً في التآمر).
بدأت الثورة ضد الاستبداد تتحول إلى حرب طائفية وطبقية يمكن أن تدمر سورية خلال جيل كامل وأن تدفع الأشخاص الماهرين والمثقفين والأثرياء إلى تحقيق طموحاتهم في مكان آخر. ما من طرف يتحدث عن ضرورة عقد المصالحة. بل تتطلب اللعبة النهائية بالنسبة إلى الفريقين تدمير الفريق الآخر. يبدو أن الداعمين الخارجيين يشجعون على المواجهة بدل أن يسعوا إلى عقد اتفاق ينقذ سورية من مصير الدول المجاورة لها مثل لبنان والعراق.
ظهر بصيص أمل بفضل كلام الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، نبيل سكر، الذي قال من دمشق: “لن تنسحب المعارضة. قد يدوم وضع المراوحة حتى عام 2014″. بحسب رأي سكر، سينتهي عهد بشار الأسد في تلك السنة وقد يتنحى حينئذ مع حفظ ماء وجهه أو بعد معاقبة طائفته العلوية.
تابع قائلاً: “كي تنجح خطة كوفي عنان، لابد من تقديم تنازلات من الفريقين. يجب أن يوقف النظام أعمال القتل ويجب أن توقف المعارضة تهريب الأسلحة. كذلك، يجب أن تتوقف الجهات الخارجية عن إرسال الأسلحة. بعد ذلك، يمكن فرض وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية”. قد يبدو هذا الحل مستبعداً اليوم، ولكنه قد ينجح إذا أقنعت روسيا وإيران النظام السوري وإذا ضغطت الولايات المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، على المعارضة لتحقيق ذلك. إذا لم يتم هذا الأمر، فسيتقاتل السوريون في ما بينهم، كما فعل اللبنانيون، وسيخوضون ما سماه الصحافي اللبناني المرموق غسان تويني “حرب الآخرين”.
* مؤلف كتب عدة عن الشرق الأوسط وناشر في مطبعة لندن “تشارلز غلاس بوكز” (Charles Glass Books). ستصدر هذه السنة نسخة جديدة عن كتابه “قبائل مع أعلام: رحلة مختصرة” (Tribes with Flags: A Journey Curtailed) عن دار نشر “هاربر